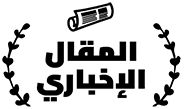إعداد: أحمد التلاوي
تصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الحديث عن التحوُّل من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، بالتطبيق على السلع التموينية، بحيث تبدو الصورة وكأن ذلك الأمر قد بات في حكم الأمر الواقع بعد إعلان الحكومة المصرية قبل أسابيع قليلة عن دراسة إمكانية تطبيق منظومة الدعم النقدي بدءًا من العام المالي المقبل.
والحقيقة أن أول ملاحظة من الواجب وضعها في الحسبان عند النظر في هذا الموضوع، هو أن هذا العنوان: “التحوُّل من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، بالتطبيق على السلع التموينية”، يرتبط بعدد كبير من القضايا الاقتصادية، وليس هذا فحسب، وإنما السياسية والاجتماعية، والأمنية أيضًا.
وبالتالي بداهةً؛ فإن أي نقاش أو قرار سياسة يتم اتخاذها ترتبط بهذا الموضوع، لا ينبغي بالمطلق أنْ يأخذها طرف واحد في الدولة، ولا أنْ يتم ذلك بناءً على اعتبار واحد من الاعتبارات السابقة؛ الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية.
فهذا الملف من التعقيد بمكان، بحيث لا ينبغي أبدًا تصنيفه على أنه ملف اقتصادي، وربما بدا ذلك واضحًا لدى الحكومة المصرية عندما دفعت هذا الاتجاه إلى جلسات “الحوار الوطني” بها الكثير من الأخطاء، وشاب النقاشات العديد، وهي نقطة سوف نعود إليها في موضع آخر من الحديث.
جانب آخر من التعقيد الذي يرتبط به هذا الموضوع، هو أن الدولة المصرية في الوقت الراهن أمام حزمة ضخمة من المشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري تراكمت عبر عقود طويلة، بحيث تحوَّلت إلى منظومة مستقرَّة من الاختلالات الهيكلية التي تشبه بؤر سرطانية مرتبطة ببعضها البعض بروابط عضوية، ذات تأثير على كل أعضاء وأنسجة الجسم.
ولعل أبرز هذه الاختلالات، هي قضية الدعم، والذي برغم كل السياسات التي تبنتها الدولة في السنوات الماضية، لا يزال يشكل عبئًا بمئات المليارات على الموازنة العامة للدولة، في وقت تعاني فيه المالية العامة من ضغوط أزمات خارجية متوالية مستمرة منذ خمسة أعوام، وتزامنت مع بعضها البعض، بدءًا من أزمة “كوفيد – 19” في ربيع العام 2020م، وحتى الحرب الحالية في الشرق الأوسط والتي امتدت من غزة إلى لبنان، مرورًا بالحرب الروسية في أوكرانيا التي اندلعت في فبراير 2022م.
ضغطت هذه الأزمات على عدد كبير من قطاعات الاقتصاد المصري، وبخاصة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ضغط على الدولة لأخذ سلسلة من عمليات التخفيض في قيمة العملة الوطنية، الجنيه المصري، منذ نوفمبر 2016م، وتخفيض الدعم، وبخاصة في قطاعات الطاقة، الكهرباء والوقود والغاز.
ويكفي هنا أن نشير إلى بعض العوامل التي كلَّفت الدولة عشرات المليارات من الدولارات، كنماذج فقط؛ الأول، الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب، بينما مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وأسعار المواد الخام بشكل عام، وهو عامل مرتبط بخسائر مباشرة تعرضت لها الموازنة العامة لمصر.
وثَمَّة عاملَيْن آخرَيْن مرتبطَيْن بفقدان عوائد مُحتَمَلَة، الأول منها، تأثير هجمات الحوثيين في اليمن على السفن المارَّة في خليج عدن وبحر العرب والبحر الأحمر، حتى ميناء إيلات الإسرائيلي، والتي أفقدت مصر عائدات مُحتَمَلَة قُدِّرت بحوالي 1.8 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، 2023م / 2024م مقارنة مع العام السابق، 2022م / 2023م؛ حيث حققت قناة السويس عوائد 7.2 مليار دولار في العام المالي الأخير انخفاضًا من 9.4 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، بنسبة 19.1% ، بحسب أرقام مجلس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وتصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
أما العامل الثاني، هو الذي تسببت فيه موجات الحرارة الاستثنائية التي تعرضت لها مصر في موسمَيْ الصيف المنصرمَيْن، مما دفع الدولة إلى وقف تصدير الغاز الطبيعي، الذي كانت تعوِّل على عوائده في رأب صدوع المالية العامة، بل والتوسع في استيراده وأنواع أخرى من الوقود للحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية لمختلف القطاعات، الصناعية والمنزلية.
ولكي نعلم حجم أثر هذه العوامل وغيرها؛ نشير هنا إلى بعض المؤشرات الاقتصادية ذات الدلالة، والتي منها أن مصر قبيل أزمة “كوفيد – 19″، في نهايات العام 2019م، كان الدولار الأمريكي قد انخفض من مستوى 21 جنيهًا، إلى ما دون مستوى 14 جنيهًا.
المؤشر الثاني، احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي كان قد ناهز الـ46 مليار دولار، من دون الاعتمادية بنسبة كبيرة على الودائع الخليجية، أو تمويلات صفقات استثنائية مثل “رأس الحكمة”، بما يعني أن هذه الاحتياطات كانت عوائد أصيلة جاءت من أداء الاقتصاد المصري منذ 2016م، عندما بدأت الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، واتخذت قرار التعويم الأول للجنيه.
فالدولة – إذًا – الآن مضطرة للتحرك تحت تأثير عاملَيْن تراكميَّيْن، وهي من أصعب الظروف التي يمكن لدولة أو لكيان ما بشكل عام، التحرك في إطارها؛ العامل الأول، ذلك الذي راكَم على الدولة المصرية أعباء جديدة، هو مستجدات الأحداث السياسية والأمنية في المنطقة والعالم، على النحو الذي أشرنا إلى بعض النماذج منها، والتي لا يزال بعضها مستمرًّا، ولا يوجد أفق واضح لانتهائه.
أما العامل الثاني، المزمن، فهو ذلك المتعلق بتراكمات عقود طويلة من سياسات اقتصادية إما فاشلة أو متناقضة، مع إهمال ملفات تنموية كبيرة كلَّفت الدولة عشرات المليارات.
فملفات مثل تصفية العشوائيات الخطرة، وإصلاح السكك الحديدية، وتبطين الترع، كلها وغيرها مما تنفذه الدولة حاليًا من مشروعات، بأسعار 2024م، التي هي أحد الأسباب التي دفعت الدولة إلى التوسع في سياسات الاقتراض الخارجي والداخلي؛ لوجود مصالح أمن قومي متعلقة بهذه المشروعات.
رؤية التكنوقراط وأوجه القصور فيها
لا يُعتَبَر الطرح الخاص بتحويل الدعم السِّلَعِي إلى دعم نقدي للمواطنين، فكرة جديدة، بل هي فكرة طرحت من قبل في حكومة أحمد نظيف، بين العامَيْن 2004م و2011م، ضمن الخطط التي كانت تتبناها الحكومة وقتها، لمعالجة الاختلالات الهيكلية المزمنة في الموازنة العامة، وتنفيذ سياسة تخارُج الدولة من كل القطاعات الخدمية والإنتاجية، والتي كانت برامج مثل الخصخصة، جزءًا أصيلاً منها، تحت تأثير سيطرة التكنوقراط ورجال الأعمال على الحكومة وقتها، حتى على وزارات خدمية إستراتيجية، مثل وزارة الصحة.
عيوب أنظة االدعم
ففي نوفمبر 2004م، أصدر مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء تقريرًا مُوسَّعًا بعنوان “دراسة التحوُّل من الدعم السِّلَعِي إلى الدعم النقدي (بالتطبيق على السلع التموينية)”، تناول كافة التفاصيل حول هذا الأمر.
التقرير قدم ذات المبررات التي طرحها مؤيدو هذه الخطوة في وقتنا الراهن، أو ما يطلقون عليه “المزايا” التي يوفرها نظام الدعم النقدي، ومنها التعويض النقدي الذي يُعتَبَر من وجهة نظرهم يمثل تعويضًا عادلاً لمحدودي الدخل من الأضرار التي سوف تلحق بهم نتيجة ارتفاع الأسعار، وفق نفس الوقت يحقق الدعم النقدي العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع.
أيضًا يقولون إن الدعم النقدي يُوجَّه مباشرة للمستفيدين، من دون وسطاء، بما يمنع تسرُّبه إلى غير مستحقِّيه.
نظير ذلك، يضمن هذا النظام انخفاض الأعباء المالية التي تتحملها الدولة، وبالتالي، تخفيض عجز الموازنة العامة.
أيضًا يرون أن التحوُّل إلى الدعم النقدي، سوف يساهم في ترشيد الاستهلاك؛ حيث يرتبط بالتخلِّي عن الدعم العَيْني عادةً اتجاه المستهلِك إلى إعادة النظر في مستويات استهلاكه بعد وصول أسعار السلع المُدَعَّمَة إلى سعرها الحقيقي، مما يؤدي إلى تخفيض الاستهلاك بصفة عامة.
رفع معدلات التضخُّم، وتسريح العمالة المُتَضَمَّنة بنظام البطاقات التموينية، وعدم وجود بديل لمواجهة الأزمات في حالة إلغاء البطاقة التموينية
بينما رأى التقرير أن نظام الدعم السِّلَعِي له عيوب، منها أنه يزيد من فرص تسرُّبه للفئات غير المستحِقَّة، وزيادة الاستهلاك من السِّلَع المُدَعَّمة، مع عدم إتاحة الفرصة أمام المستفيدين لحرية اختيار السِّلَع الاستهلاكية.
وبالطبع، فإنه بالنسبة للمتخصصين، فهذا يُعتَبَر حديثًا فارغ المضمون، ويبدو سهولة تفنيد مسألتَيْ ترشيد الاستهلاك وإتاحة الفرصة أمام المستفيدين لحرية اختيار السِّلَع الاستهلاكية.
فالشعب المصري – وهذا موجود بوضوح في دراسات كثيرة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية – ومنذ الانفتاح غير المُرَشَّد في منتصف السبعينيات، أي منذ حوالي خمسين عامًا، نَمَت لديه طبيعة استهلاكية يطلق عليها بعض المتخصصين مصطلح “السُّعار الاستهلاكي”.
وحتى الحكومة الحالية تقول بوضوح أنها تسعى إلى ترشيد هذا الانفلات الاستهلاكي عند المواطن المصري بواسطة بعض الإجراءات التَّقشُّفِيَّة، وهو ما لم تُجدِ حتى الارتفاعات المتوالية في الأسعار، ونسب التضخم الكبيرة، في كبحها.
وتكفي هنا الإشارة إلى معدلات استهلاك السجائر، التي ارتفعت أسعارها بنسب تزيد على خمسمائة إلى سبعمائة بالمائة، بينما هي ليست حتى سلعة غذائية أو ضرورية ما شابه.
الأمر الآخر، أن النظرة التي يطرحها الجهاز الحكومي، هي نظرة أحادية الجانب، نظرة اقتصادية، ترى الأمور من منظور واحد، وهو الاختلالات الحاصلة في المالية العامة للدولة، لكن من دون التعمُّق في الأبعاد الاجتماعية، ومن دون النظر مطلقًا إلى الجوانب السياسية والأمنية.
مخاطر اجتماعية وأمنية
فيما يخص الأبعاد الاجتماعية؛ فإن الحديث عن باقي المبررات لهذا القرار، مثل “ضمان وصول الدعم إلى مستحقِّيه”، وأن الدولة سوف تضع ضوابط وتطرح مبادرات من أجل معالجة أية آثار سلبية قد يؤدي إليها هذا النظام، فالتضخُّم في مصر غير مسيطَر عليه بالكامل، ومؤشراته تظهِر ذلك؛ حيث يتحرَّك صعودًا وهبوطًا في السنوات الأخيرة، بصورة تبرز عدم السيطرة عليه، بجانب ان ارتفاعات الأسعار في الأصل، تنجم في غالب أسبابها عن عوامل لا علاقة للدولة بها، والحكومة تعلم ذلك، وتقوله، ويعلنه السيد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي في كل مؤتمر صحفي يعقده.
فأزمات مثل “كوفيد – 19” والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في غزة، ثم لبنان، ومواسم ارتفاع الحرارة الكبيرة؛ كلها عوامل خارجة عن الإرادة، وغير قابلة لا للتنبُّؤ، ولا للتحكُّم فيها، بينما التغيير سوف يطال أحد أهم ركائز الأمن الغذائي لدى المواطن المصري؛ حيث بطاقة التموين، وبطاقة صرف الرغيف المدعوم، توفر له الحد الأدنى، متى كان العَوَز والفقر شديدًا في بعض الأُسَر.
وهنا، لا يمكن الركون إلى حالة الهدوء التي رافقت تمرير قرارات مؤلمة بالنسبة للمواطنين، مثل رفع سعر رغيف الخبز المدعَّم في مايو الماضي بنسبة أربعمائة بالمائة، من خمسة قروش إلى عشرين قرشًا للرغيف، ورفع شرائح استهلاك الكهرباء في أغسطس الماضي، وقبلها شهد العام 2024م رفعَيْن متتاليَيْن لأسعار الوقود، في مارس ويوليو، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في سعر أنبوبة البوتاجاز بنسبة ثلاثمائة بالمائة.
فسلوك المواطن المصري وردة فعله، كما أثبتت كبار الحوادث في السنوات بل والعقود الماضية، أنه لا يمكن التنبُّؤ بها.
ونقطة أخرى مهمة هنا، وهي أن سلوك المواطن هذا، مخيف في نقطة الطبيعة الاستهلاكية غير الرشيدة، ما دفع حتى الجمعيات الخيرية الى التحول لتقديم مساعدات عينية بدلا من المساعدات المالية.
“الحوار الوطني” وضرورات أخذ جانب الحذر
بعدما طرح الدكتور مصطفى مدبولي مسألة التحوُّل من الدعم السِّلَعِي إلى الدعم النقدي، في يونيو الماضي، ظهرت اعتراضات وتحفظات عند أوساط كثيرة، منها حتى نواب في البرلمان، ودعوا إلى ضرورة دفع هذا الموضوع إلى حوار مجتمعي شامل.
لكن ما حدث، هو أنه تم وضعه أمام جلسات “الحوار الوطني”، وهنا بعض الملاحظات الواجب أخذها في الاعتبار، وتدفع إلى أخذ جانب الحذر من توصيات المجتمعين هناك، ومنها مشكلة مزمنة تعاني منها الدولة من بعض الأشخاص الذين تعتبرهم محل ثقة، وبالتالي، تسألهم المشورة في كثير من الأمور.
فكثير حتى من مستشاري الدولة الرسميين، يعطون آراء وتوصيات بناء على ضرورة دعم التوجه الحكومي ويصدرون آراء وتوصيات تتماشى مع ما يستشعرون أنه موقف الحكومة أو الدولة.
الملاحظة الثانية، تتعلق بأن بعض الأطراف المنخرطة في جلسات “الحوار الوطني”، هي في الأصل معارِضة للنظام الحالي في مصر، ولا ترغب في أن يستمرَّ، وتطرح مبررات عديدة لذلك، وقد يوجِّه بعضهم بتوصية، قد لا تكون في مصلحة الاستقرار الداخلي.
يرتبط بذلك قضية شديدة الأهمية، وهي الدور الذي تلعبه القوات المسلحة المصرية في حراك التنمية والملفات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها الأمن الغذائي.
فمثلما يطرح البعض في الداخل توصيات على أنها مفيدة، وفي الصالح العام، وأن الهدف منها اقتصادي بحت، بينما لها أبعاد سياسية أخرى، عندما تطالب بعض الجهات المانحة الخارجية، ورجال الأعمال وأطراف سياسية في الداخل بتقليص وجود القوات المسلحة في الاقتصاد، فإنهم يطرحون ذلك باعتباره رؤية “إصلاحية”، بينما الهدف غير ذلك؛ حيث إن سحب القوات المسلحة لدورها التنظيمي على الأقل من ملف الأمن الغذائي؛ سوف يعني ارتفاعات مضاعفة للأسعار، وللتضخم، بصورة لن يتحمَّلها بكل تأكيد المواطن محدود الدخل.
فهنا نحن – إذًا – أمام أمر لا يضعه المجتمعون في “الحوار الوطني”، وخبراء الحكومة من التكنوقراط في حسبانهم، أو قد يراه البعض منهم، ولكنه يغضُّ الطَّرْف عنه.
ملاحظات أخيرة
مما تعلمناه في العلوم السياسية، أن التوصية تتم على أساس مطابقة النماذج التي تشترك في طبيعة واحدة ببعضها البعض، لاستخلاص نتيجة صحيحة.
ولتوضيح الأمر؛ فإن ذات المنطق الذي دفع أجهزة المعلومات والتقييم الإستراتيجي في مصر لعقود طويلة للتوصية للقيادة السياسية بعدم المساس بمنازل الإيجارات القديمة، بسبب مساس ذلك بمصالح عشرات الملايين من محدودي الدخل؛ فإن ذلك الاعتبارات تنطبق على موضوع التحوُّل من الدعم السِّلَعِي التمويني إلى الدعم النقدي.
وبالتالي؛ فإنه على أقل تقدير؛ على الدولة التعامل الحَذِر، التدريجي، طويل المدى مع هذا الملف مثلما تعاملت مع ملف الإيجارات القديمة على النحو الذي نراه الآن.
أيضًا، يجب أنْ تعلم الدولة أن مبادرات مهمة فعلاً مثل “حياة كريمة”، لا تصل في أثرها وأهميتها إلى أثر وأهمية رغيف الخبز المُدَعَّم، والدعم السِّلَعِي التمويني، مع ضرورة استمرار القوات المسلحة في دورها الاقتصادي في مجال الأمن الغذائي.
لا نتحدث هنا عن الضرورات الفنية التي تفرض وجود هيئات عسكرية مثل الهيئة الهندسية في تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة، وإنما بالتحديد في موضوع الأمن الغذائي.
هذه العناصر الثلاثة؛ رغيف الخبز المُدَعَّم، والدعم السِّلَعِي التمويني، ودور القوات المسلحة الضابط والضامن في مجال الأمن الغذائي، هي أصل من أصول الاستقرار الداخلي في مصر بكل معاني الاستقرار.
ويفرض ذلك عدم الاندفاع كثيرًا في الاستجابة لمطالب رجال الأعمال لإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للعب دوره.
بكل تأكيد، دور القطاع الخاص شديد الأهمية، والساق الثانية في أية دولة للاقتصاد والتنمية، ولكن ليلعَب دوره في قطاعات الصناعة والزراعة، ولكن ليبقى الأمن الغذائي ومبادراته في قبضة الدولة ممثلة في القوات المسلحة، بالتعاون مع مبادرات وزارات أخرى، مثل “الداخلية” و”التموين” و”الزراعة”؛ تتضامن فيها مبادرات مثل “كلنا واحد” و”أمان”، وغيرها في سبيل عدم انفلات أسعار المواد الأساسية، وضمان وصولها إلى الناس.
وأخيرًا؛ فإن أية مبررات فنية مطروحة للتحوُّل من الدعم السِّلَعِي التمويني إلى الدعم النقدي، والتي منها “ضمان وصول الدعم إلى مُستَحقِّيه” هذه التي هي عمود الأساس لدى مؤيدي هذه الفكرة، يمكن للدولة بواسطة إجراءات ضابطة رقابية أكثر صرامة تحقيقها من دون أخذ هكذا قرار، على الأقل بصورة عشوائية / سريعة، قد لا تضمن معها الدولة رِدَّة فعل المواطن والمجتمع بشكل عام، لاسيما في ظل الإرهاق الكبير الذي يعاني منه المواطنون، حتى من الشرائح الأكثر ثراءً، ويعترف به دائمًا أكبر سلطة في الدولة، وهو السَّيِّد رئيس الجمهورية.