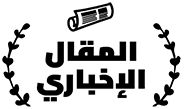إعداد: أحمد التلاوي
يطرح الحدث السياسي والعسكري الراهن في المنطقة العربية والشرق الأوسط، الكثير من الأمور على كل الأطراف المعنية بأمن واستقرار هذا الوطن.
وعندما نقول “كل الأطراف”؛ فإننا لا نعني سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة، وإنما نعني أيضًا المواطن، الذي عليه العبء الأكبر، باعتبار أنه صاحب المصلحة الأولى في هذا البلد
ولكن قبل الدخول إلى بعض المفاهيم التي نرى أنه من الضروري إلقاء الضوء عليها والإلمام بها من جانب المواطن العادي، الجمهور العام، الشعب المصري، في هذه الفترة، التي تواجه فيها المنطقة اضطرابات واسعة، من الواجب إلقاء الضوء على بعض المشاهد و”اللقطات” ذات الدلالة.
مشاهد تعكس حالة الاستقرار السياسي والأمنيالمشهد الأول.. تعمل سلطات محافظة القاهرة والأجهزة الحكومية المعنية، في الوقت الراهن على الترتيب لاستضافة النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحَضَري العالمي (WUF12)، والذي يُعَدُّ ثاني أهم منتدى علي أجندة الإمم المتحدة بعد مؤتمر قمة المناخ، والذي سبق وأنْ استضافت مصر نسخته السابعة والعشرين (COP27) في نوفمبر 2022م..
المشهد الثاني.. في الأول من أكتوبر الحالي، قامت إيران بإطلاق نحو مائتَيْ صاروخ تجاه إسرائيل، ضمن التصعيد الحالي الذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023م، في المقابل، ظلَّت أجواء جمهورية مصر العربية آمنة، وكانت موثوقية الأمان عالية، لدرجة أن مختلف خطوط الطيران الدولية، حولت مسارات طائراتها المدنية إلى الأجواء المصرية.
المشهد الثالث.. احتفالات مصر بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية الشرطة والكليات العسكرية، بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشَّيْخ محمد بن زايد، للمرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” التنموي على السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية.
هذه المشاهد تعكس حالة من الاستقرار السياسي والأمني والمجتمعي، وكذلك المؤسسي لدى أجهزة الدولة.
فالمؤتمر المذكور، تابع للأمم المتحدة، وأهميته معروفة، والمنظمة الدولية لن تُجامل مصر وتسنِد إليها تنظيمه لأي سبب، ولولا استحقاق مصر لذلك؛ لجهة توافر كل أسباب نجاح المؤتمر، بما في ذلك التنظيم، وتأمين الضيوف الدوليين المشاركين فيه.
ننتقل بقفزة في الزمان، إلى الخلف، ربما بقرن من الزمان. بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، وبالتحديد في العام 1919م، وضعت أجهزة المخابرات البريطانية عددًا من التقييمات حول الموقف في مستعمراتها ما وراء البحار، ومنها الموجودة في المنطقة العربية والشرق الأوسط الكبير، والذي يضمُّ دولاً ومناطق مثل إيران وتركيا وأفغانستان، وباكستان، شرقًا، والقرن الأفريقي ومنابع النيل الاستوائية جنوبًا.
هذه التقييمات توقعت أنْ تخرج بريطانيا من أكثرية مستعمراتها، بحلول منتصف القرن العشرين، وكان مما يخص مصر منها بالمناسبة، أن يحدث تغييرًا عميقًا في بُنية النظام السياسي المصري بقيادة الجيش، عندما تصل أولى الدفعات التي تم قبولها من المصريين في الجيش المصري، في العام 1918م، إلى مراكز قيادية متقدمة في الجيش، وهو ما حدث بالفعل، في العام 1952م، عندما قام “الضباط الأحرار” بثورة 23 يوليو.
والقوى الدولية الكبرى مثل بريطانيا، عندما تضع أجهزتها الإستراتيجية تقديراتها وخططها، فإنها تضع في حسبانها ضمان مصالحها الآنية مستقبلاً، ويكون ذلك على مدىً زمنيٍّ طويل، قد يصل إلى قرن أو اثنين من الزمان.
وهذه ليست من قبيل المبالغات، ويكفي هنا أنْ نشير إلى أنْ مخطط فصل جنوب السودان المسيحي الأكثر أفرقة عن شماله المسلم الأكثر عروبةً، قد بدأ قبل نحو 140 عامًا، وكانت خطوة بريطانيا الأولى في ذلك، هي إبعاد الموظفين المصريين ومُعَلِّمي اللغة العربية المصريين أيضًا من جنوب السودان.
نشير هنا أيضًا إلى أن مؤرخي أنظمة الاستخبارات في بلدان عريقة في هذا المجال، مثل روسيا وبريطانيا، أدرجوا نماذج وخطط لعمليات استخبارية، قد يصل مداها الزمني إلى قرن وأكثر من الزمان، لغرس عملاء، وتجذيرهم في المجتمعات العَدُوَّة، أو لتحقيق أثر سياسي واجتماعي طويل المدى.
المهم، وضمن هذا السياق المفاهيمي، كانت خطط الاستعمار البريطاني تقوم على مبدأ مركزي مهم، وهو خلق أوضاع ذات تأثيرات طويلة المدى، تضمن دائمًا وجود “شرق أوسط غير مستقر”.
وهدفت بريطانيا، ووريثتها الاستعمارية، الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية، إلى تحقيق مجموعة من الغايات الإستراتيجية تضمن دائمًا استمرار تدفُّق مصالحها في هذه المنطقة بسلاسة، وعلى رأسها، إمدادات الطاقة، وأمن إسرائيل، ومبدأ الرأسمالية الأهم؛ حرية حركة الملاحة والتجارة العالميَّتَيْن، للمواد الخام، وعوامل الإنتاج الأخرى، والمنتجات الصناعية والزراعية، من وإلى الغرب.
هذه الغايات لن تتحقق إذا ما كان هنا استقرار يضمن شكلاً من أشكال التعاون ما بين بلدان وقوى هذه المنطقة الكبيرة الواسعة، والمهمة للسياسة العالمية، مع مجاورتها للكتلة الأوراسية، التي تُعتَبَر الخانق الأهم للأمن القومي الأوروبي، ومركز السياسات العالمية منذ قرون بعيدة، عندما ظهرت روسيا وإنجلترا كقوى فاعلة في أوروبا بين القرنَيْن العاشر والحادي عشر الميلاديَّيْن.
خطط بريطانيا للتعطيل الحضاري
تتضمن هذه الخطط طائفة واسعة من التحركات التي ترمي إلى تحقيق عدد من الأهداف المرحليةأولا: إيجاد بذور صراعات، إقليمية وداخلية في بلدان الإقليم.
ثانيا: تفكيك المركزيات الكبرى في المنطقة، أي الدول الكبيرة ذات التأثير السياسي والثقافي والروحي، مثل مصر، وباكستان، وتركيا، والجزائر، وسوريا.
ولأجل ذلك، تم وضع أسس الحدود الحالية، غير المستقرة بين كثير من بلدان المنطقة، والتي لا تراعي الحقائق الجيوسياسية والجغرافية والبشرية على الأرض، ولا حقائق التاريخ، لتكون دائمًا بؤرة نزاع وتباعُد.
ثالثا: إثارة النعرات القومية المحلية، ودعم الحركات الانفصالية في كل مكان، كما حدث في حالة الأكراد بين سوريا والعراق وجنوب تركيا، والأمازيغ في المغرب العربي.
رابعا: زرع بذور الفتنة من خلال منظومة من السياسات التي تخلق واقعًا ونقيضه، بحيث يدخل هذا الواقع وهذا النقيض في صراع دائم.
فمن المعروف أن بريطانيا تقف بشكل أو بآخر خلف تأسيس جماعات ما يُعرَف بـ”الإسلام السياسي”، وعلى رأسها جماعة “الإخوان المسلمون”، والجماعة الإسلامية في شبه القارة الهندية التي أسسها أبو الأعلى المودودي.
في المقابل، كان – وفق وثائق معلنة – لبريطانيا دور في تأسيس الجامعة العربية، عقب الحرب العالمية الثانية، ومن قبل ساعدت الشَّريف الحسين بن علي في شبه الجزيرة العربية عندما قام بما أُطلِقَ عليه “الثورة العربية الكبرى” خلال الحرب العالمية الأولى، لإضعاف الدولة العثمانية، وإخراجها من الحرب، ثم تفكيكها بعد ذلك كما حدث من خلال سلسلة من الاتفاقيات بالتعاون مع فرنسا، القوة الاستعمارية الكبرى الثانية في المنطقة، مثل اتفاقية “سايكس – بيكو” و”معاهدة لوزان”.
وهنا من المهم الإشارة إلى أنه بجانب إشعال فتيل الصراعات البينية والداخلية في المنطقة ودولها، هَدَفت مثل هذه النوعية من السياسات إلى تحقيق هدف آخر مهم، تُعتَبَر هذه الصراعات أداة من ادواته، وهي تعطيل نماذج التنمية المستقلة التي تظهر، مثل تجربة محمد علي باشا الكبير وجمال عبد الناصر في مصر.
فالتنمية الذاتية المستقلة من أكبر الأخطار التي تواجه المصالح الغربية الكبرى في أي مكان في العالم، فهي تهدد صلب منظومة الرأسمالية العالمية ذاتها، والتي بدأت تتشكل بحركة الكشوف الجغرافية التي بدأت في القرن الخامس عشر الميلادي؛ حيث تعمل البلدان والدول المختلفة على استغلال ثرواتها من المواد الخام، وتحمي منتجاتها داخل أسواقها، وهو ما يمسُّ عصب النظام الرأسمالي الغربي القائم على استغلال المواد الخام لدول العالم الأخرى.
لذلك يرى البعض أن القطاع الصناعي الصيني هو أكبر مُهَدِّد ظهر للنظام الرأسمالي الغربي، بأكثر مما فعلته ألمانيا النازية، أو حتى السياسات الروسية في منطقة أوراسيا، لأنه يمسُّ صلب منظومة الهيمنة الغربية على النظام الاقتصادي العالمي.كما أن تعطيل التنمية الذاتية المستقلة لبلدان المنطقة، يضمن لهذه القوى دائمًا مواصلة سيطرتها – من خلال أدوات الأمن والاقتصاد السياسي – على قرار هذه البلدان، التي تظل دائمًا في حالة من الضعف، وبالتالي الاحتياج للقوى الإمبريالية الكبرى، فتبقى على تبيعتها لهذه القوى، حتى بعد خروج الاستعمار المباشر منها، ولاسيما في ظل ظروف الصراعات البينية التي اختلقتها الخطط البريطانية قبل المغادرة.
“الربيع العربي” وعلاقته باستراتيجيات “التعطيل الحضاري
في الحقيقة، فإن ما مضى هو خطوط أو عناوين عامة فقط يندرج تحتها آلاف من التفاصيل والأحداث الكبرى التي مرَّت بالعالم العربي والشرق الأوسط الكبير خلال العقود الطويلة الماضية، والتي تحتاج إلى كتب ومجلدات ضخمة لترويها.
ولكن المهم أنْ نفهم هذا الإطار العام، كان هذا المنطق هو صُلب منظومة الاحتجاجات التي بدأت في عالمنا العربي في العِقد الأول من الألفية الجديدة، وبدأ التجهيز لها قبل ذلك بعقود طويلة، منذ السبعينيات، عندما بدأت خطط توسيع مساحة “الإسلام السياسي” في المجتمعات العربية، وخلق رؤوس حربة أكثر فاعلية للتغلغل الغربي والصهيوني في مجتمعاتنا، من أجل ضربها من الداخل.
في العام 2004م، تكلَّمت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس صراحة عن مصطلح “الفوضى الخلَّاقة” كجزء من تبعات أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م.
ولكننا أصبحنا في أدبياتنا السياسية، نطلق عليها “الفوضى الهدَّامة”، بعد أنْ تطورت على النحو الذي رأيناه في الفترة التي تلت ثورات ما يُعرَف بـ”الربيع العربي” والتي لا نزال نعاني من آثارها السلبية على البُنى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، في مصر، وفي بلدان عربية أخرى، بعضها لم يخرج ولا يبدو له خروجًا من حالة التخريب والتفكيك التي بدأت، مثل ليبيا واليمن والسودان.
ولا يمكن فصل الصراع الحالي في الشرق الأوسط، والذي تنخرِط فيه إيران بشكل مباشر، عن هذا الذي نقول؛ حيث ترتبط الحروب الحالية في المنطقة بسياسات تفكيك المركزيات.
ففي الأصل، النظام الإيراني بهويته القومية والمذهبية، تمت زراعته ورعايته في الغرب، فالخُميني، جاء إلى إيران من فرنسا في العام 1979م، وكانت كتبه ومحاضراته وخطبه تتم كتابتها وتسجيلها في أوروبا، ثم إرسالها إلى إيران، لاستكمال دائرة الأنظمة والجماعات الأصولية المتناقضة الهوية في المنطقة.
وكانت آخر حَبَّة في عقد هذه المنظومة الشيطانية، تنظيم الدولة “داعش”، الذي من المعروف أنه خلال سنوات نشاطه في سوريا والعراق بين العامَيْن 2014م و2018م، كان يتم تجنيد المرتزقة الذين يقاتلون في صفوفه، من خلال مكاتب في لندن، بمعرفة أجهزة الاستخبارات البريطانية.
“الجمهورية الثانية” واستجابة مختلفة
في العقود التي سبقت حالة الفوضى والأزمة الحالية في منطقتنا العربية ومن ورائها الشرق الأوسط، كانت استجابات الأنظمة الحاكمة لمثل هذه الخطط، سلبية الطابع، بين حالَيْن.
في الحالة الأفغانية في الثمانينيات الماضية – إمَّا تورَّطت في دعم الخطط الغربية، أو أنها انساقت إلى صراعات ومواجهات غير مأمونة العواقب، استُدرِجَت لها، وأتت على حساب أمنها القومي ومصالح شعوبها، ووضعتها في دائرة مفرغة، كلفتها ميزانيات هائلة للأمن والدفاع، من دون أي رافد تنموي أو اقتصادي ذاتي لتمويل هذه التكاليف.
إلا أن الدولة المصرية، في بدايات تأسيس الجمهورية الجديدة أو “الجمهورية الثانية” قبل نحو عشر سنوات، كانت على موعد مع لحظة تنوير مهمة، فهمت فيها هذه الأرضية المفاهيمية السابقة، واستوعبت دروس العقود السابقة التي ساهمت في تدعيم سياسات التخريب الداخلي البطيء في مصر.
وهي السياسات التي ظهرت آثارها في هشاشة البُنيان الذي وجدته الفوضى التي اندلعت في العام 2011م، واستغلت فيها قوى كثيرة داخلية زُرِعَت في الأصل بواسطة القوى الاستعمارية التقليدية، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، لمطالب الشعب المصري العادلة في ثورة يناير، من عيش وحرية وعدالة اجتماعية.
فبدأت الدولة المصرية في سياسات ترتكز على قائمتَيْن أساسيتَيْن، بعد دراسة عميقة لما جرى، القائم الأول، تبني منظومة شاملة لسياسات الأمن القومي، تخرج عن نطاق المفهوم القريب للأمن القومي، إلى المفهوم الشامل له.
وهذا المفهوم تضمن الكثير من الأمور، كان أساسها دعم القوات المسلحة، والتوسع في حماية مصالح الأمن القومي المصري المختلفة داخل وخارج البلاد، وحماية الجبهة الداخلية، من خلال تفكيك بُنية القوى القديمة التي لعبت أسوأ الأدوار في إضعاف المجتمع من الداخل.
كما كان ولا يزال من بين أهم أهداف هذه الإستراتيجية الشاملة للأمن القومي، حماية مؤسسات الدولة الدستورية، وضمان استمرار هذه المؤسسات في أداء دورها، حتى لو تكرر سيناريو “جمعة الغضب” في 28 يناير 2011م.القائم الثاني الذي استندت إليه الدولة الجديدة في مصر، في هذا الإطار، إعادة هيكلة البُنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مصر بالكامل، وتبنِّي خطط تنمية شاملة، بعيدة المدى، تعمل على تعويض ما فات، وتعظيم استفادة مصر مما تملكه من ثروات، والبحث عن مكامن ثروة جديدة لها.
كما تضمنت هذه السياسات، التوسع في خطط التنمية الصناعية والزراعية، وتشمل كل مكان في مصر، حمايةً لوحدة التراب الوطني، والحفاظ على ترابط أقاليم الدولة المختلفة، وضمان وجود مؤسساتها ومواطنيها في كل مكان منها، مع إيلاء شبه جزيرة سيناء أهمية خاصة في هذا الإطار، في ظل ما قادت إليه سياسات عقود من الإهمال لها، إلى تهديد ارتباطها بالوطن الأُمِّ، مصر، وفق ما تكشَّف في السنوات الأخيرة من خطط لعبت فيها قوى داخلية وخارجية أسوأ الأدوار لتحقيقه، لكي تكون سيناء هي أرض الوطن الفلسطيني البديل؛ خدمةً لمصالح إسرائيل، وخططها بعيدة المدى.
وفي الأخير؛ رأينا في مصر في السنوات القريبة الماضية، أمورًا لم تكن مطروحة من الأصل، كانت غائبة عن أجندة العمل الوطني تمامًا، مثل برامج فضاء وتصنيع عسكري مصرية بالكامل، والحديث عن صناعات دقيقة ومهمة للغاية، مثل صناعة المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، وتوطين تكنولوجيا حساسة مثل تكنولوجيا الاتصالات، واقتحام سوق الطاقة النظيفة، بحيث أصبحت مصر في غضون سنوات قليلة رائدةً فيه.
بدأت مصر تنافس في مجالات شتَّى، وصارتالدولة على أكبر قدر من الانتباه والفهم لحقيقة ما يُدار في الخفاء لها، وللمنطقة بالكامل، فعَمِلَت على تعزيز عناصر قوة الدولة، ومواجهة نقاط الضعف.
صحيح أننا نواجه مشكلات كبيرة، إلا أن مواجهة هذه المشكلات عن فهم، أفضل بمراحل من تركها من دون التعامل معها، أو من دون فهمها، بحيث يمكن أنْ نقول باطمئنان وثقة، أن مصر تُعتَبر نموذجًا هو الأول من نوعه لبلد كان ولا يزال مستهدَفًا بخطط قوى الشر الإقليمية والدولية، قد نجح في رسم منظومة من السياسات، تغلبت بالفعل على إستراتيجيات التعطيل الحضاري، وكان أول خطوة فيها، أهم خطوة، وهي التنوير والفهم.